-
الكورد مرآة الوطن المكسورة
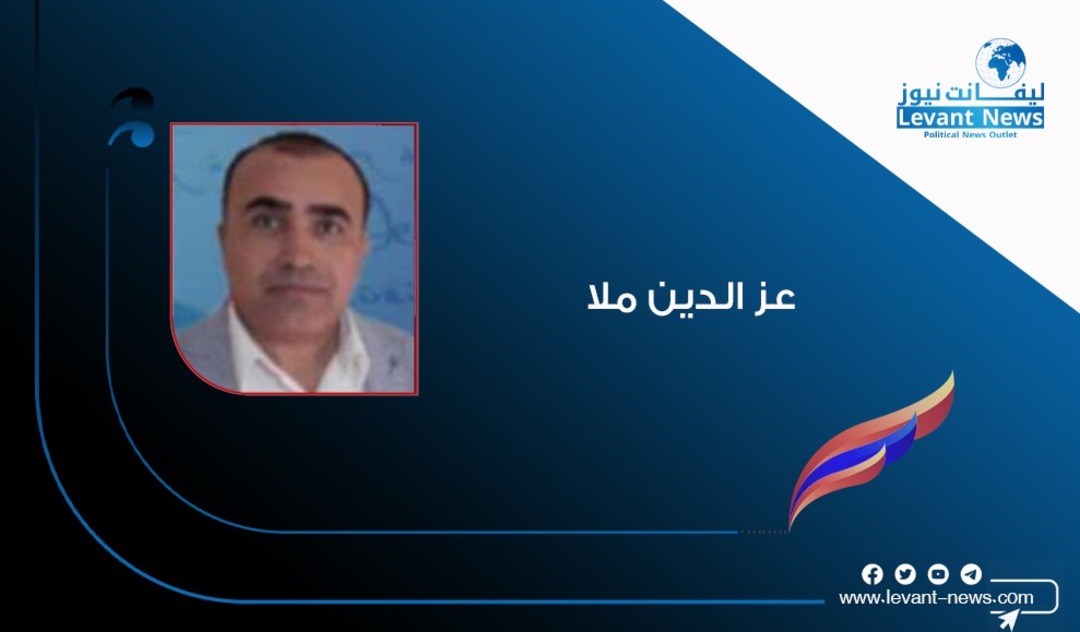
الكورد مرآة الوطن المكسورة
الكاتب: عزالدين ملا
صحيح أن سوريا بلد متنوع من حيث مكوناته القومية والدينية والمذهبية، وأن هذا التنوع كان في الماضي، أحد أبرز سماته الثقافية والحضارية، غير أن ما يميّز البنية الاجتماعية السورية بوضوح هو وجود قوميتين مركزيتين تشكلان عماد الهوية الوطنية، القومية العربية والقومية الكوردية.
العرب يشكلون الغالبية السكانية، بينما الكورد قومية أصيلة متجذّرة في تراب البلاد، لها لغتها وذاكرتها الجمعية وثقافتها التي تمتد جذورها في عمق التاريخ السوري، قبل رسم حدود الدولة الحديثة. هذه الثنائية ليست مجرد تنوعٍ اجتماعي، بل معادلة وجودية تحدد مستقبل الوطن وتختبر مدى نضج مشروعه الوطني.
لقد كان الرابط الديني، ولا سيما الإسلام السني، عاملاً توحيدياً ساهم عبر عقود في تخفيف حدة الانقسامات، لكن هذا الرابط لم يكن كافياً لتجاوز المسألة القومية، لأن الانتماء القومي يرتبط بالاعتراف والحقوق والكرامة، لا بالانتماء الطقوسي أو الرمزي. فالقضية الكوردية، في جوهرها، ليست مسألة ثقافية فحسب، بل قضية سياسية تتعلق بمكان الكورد في الدولة السورية وبمدى حضورهم في صناعة القرار وتشكيل الوعي الوطني المشترك.
منذ تأسيس الدولة السورية الحديثة، تعاملت السلطات المتعاقبة مع الكورد بعين الريبة والشك، ضمن مقاربة أمنية ضيّقة رأت فيهم مواطني حدود لا مواطني وطن. كان الإحصاء الاستثنائي عام 1962 في الحسكة لحظة مفصلية في تكريس هذا التمييز، إذ جُرّد عشرات الآلاف من الكورد من الجنسية السورية، فحُرموا من أبسط حقوق المواطنة، التعليم، التملُّك، السفر، وحتى الاعتراف بأسمائهم الحقيقية، والحزام العربي بجلب آلاف من عوائل غمر الرقة واستيطانهم في أراضي الكورد وقراهم بعد أن تمَّ سلبها بالقوة. ترافقت تلك السياسات مع منع اللغة الكوردية من الظهور في الفضاء العام، وتجفيف تمثيل الكورد في مؤسسات الدولة. وهكذا نشأ شعور قومي عميق بالاغتراب، لم يكن موجّهاً ضد العرب، بل ضد بنية السلطة التي اختزلت الدولة في هوية واحدة وصوت واحد.
حين انهار النظام القديم، وفرّ رأسه من البلاد، شعر الكورد كما كثير من السوريين أن صفحة جديدة تُفتح في التاريخ، صفحة تُكتب بدماء الحرية وتوق العدالة. لم يكن ذلك الفرح مجرّد نشوة بسقوط استبداد، بل كان ترجمة لتطلعٍ طويل نحو الاعتراف بالذات القومية، وعودة للكرامة التي حُرموا منها عقوداً. لكن سرعان ما اصطدم الحلم بواقع السياسة، فالدستور المقترح والحوارات الوطنية لم تحمل إشارات جدّية إلى معالجة المسألة الكوردية، ولا إلى إعادة تعريف الدولة على أسس تعدُّدية. بل أعادت إنتاج الرؤية الأحادية ذاتها التي جعلت من العروبة هوية الدولة الوحيدة، متجاهلةً التعدُّد القومي الذي يشكّل أحد منابع غناها التاريخي.
جاء المؤتمر الوطني في دمشق ليعمّق خيبة الأمل، إذ غابت فيه الرؤية الشاملة لحقوق الكورد، وغُيّب ممثلوهم عن طاولة صياغة المستقبل. أدرك الكورد عندها أن ما يجري ليس تأسيساً لعهد جديد، بل إعادة إنتاجٍ للذهنية الإقصائية ذاتها التي خنقت سوريا لعقود. عند هذه اللحظة الحاسمة، أعادت القوى الكوردية النظر في استراتيجيتها، وانتقلت من موقع الانتظار إلى موقع الفعل، فبرز الالتفاف حول رؤية كوردية موحدة وشاملة.
لقد شكّل هذا الالتفاف تحوّلاً نوعياً في الوعي السياسي الكوردي. فبعد أن ظلت الحركة الكوردية لعقود منقسمة بين تيارات متباينة، توحّد الخطاب السياسي حول فكرة واضحة، أن لا معنى لوطنٍ لا يعترف بجميع أبنائه، وأن الكرامة القومية لا تتناقض مع الولاء الوطني. جاء انعقاد الكونفرانس الكوردي في 26 نيسان 2025 كتعبير عن إرادة جمعية تسعى إلى ترسيخ رؤية كوردية ووطنية متوازنة، تؤكد أن الكورد لا يطلبون الانفصال، ولا يسعون إلى تقسيم البلاد، بل إلى الاعتراف الدستوري بوجودهم كشركاء كاملين في الوطن، لهم حق إدارة شؤونهم المحلية في إطار دولة ديمقراطية لا مركزية.
في هذا السياق، برز الدور التاريخي للرئيس مسعود بارزاني، بوصفه رمزاً قومياً يتمتع بشرعية نضالية وروحية كبيرة في الوجدان الكوردي. فبينما كانت الساحة الكوردية السورية تعاني من الانقسام والتشتت، عمل البارزاني على مدّ الجسور بين القوى السياسية الكوردية المختلفة، داعياً إلى وحدة الصف والرؤية ضمن الإطار الوطني السوري. لم ينظر البارزاني إلى المسألة الكوردية في سوريا بوصفها قضية معزولة، بل كجزء من المسار الكوردي العام الذي يتوزع على جغرافية كوردستان.
لقد مارس دور المرجعية الأخلاقية التي تذكّر أن قوة الكورد لا تكمن في السلاح أو الشعارات، بل في وحدتهم ورؤيتهم المشتركة. ومن خلال رعايته للمشاورات واللقاءات بين الأطراف الكوردية السورية، ومحاولاته المستمرة لخلق أرضية تفاهم بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية، ساهم البارزاني في بلورة خطاب سياسي متوازن يجمع بين الواقعية والتمسُّك بالحقوق التاريخية.
كانت رسالته الدائمة أن الحق القومي لا يتعارض مع الانتماء الوطني، وأن الكورد في سوريا ينبغي أن يكونوا جسراً للوحدة الوطنية لا سبباً للانقسام. ومن هذا المنطلق، شكّل دعمه المعنوي والسياسي دافعاً مهماً للحركة الكوردية السورية كي تتعامل بثقة مع التحديات، دون أن تقع في فخ الانعزال أو الصدام. وهكذا، تحوّلت رؤيته إلى عامل استقرار داخل البيت الكوردي، وإلى صوت عاقل يذكّر الجميع أن تحقيق الحقوق لا يكون بالتصادم بل بالحوار، ولا بالانغلاق بل بالشراكة.
ورغم أن الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع أرسلت إشارات إيجابية، وأطلقت تصريحات تدعو إلى احترام حقوق الكورد وضمان تمثيلهم، إلا أن الذاكرة الكوردية المثقلة بالوعود المنقوضة لم تعد تصدّق الأقوال دون أفعال.
إن التمسك بالنظام المركزي في بلد مثل سوريا، متنوّع الأعراق والمذاهب، ليس فقط خطأً سياسياً، بل انتحارٌ وطني. فالمركزية المفرطة كانت عبر التاريخ السوري مصدراً للتهميش والاحتقان، وكل محاولة لإحيائها ستعيد إنتاج الصراع ذاته بأشكال أكثر عنفاً. الكورد، شأنهم شأن أيّ مكوّن وطني، لا يطالبون بامتيازات فوقية، بل بحقوق عادلة، حق التعلُّم بلغتهم، وحق المشاركة في القرار السياسي، وحق إدارة مناطقهم ضمن نظام إداري لا مركزي يوزع السلطة والموارد بعدالة.
اللامركزية ليست تفكيكاً للوطن كما يروّج البعض، بل إعادة لتركيبه على أسس أكثر صلابة وعدالة. وسوريا، التي أنهكتها الحرب والانقسام، لا تحتاج إلى مزيد من الشعارات عن الوحدة، بل إلى وحدة مبنية على الاعتراف والتشارك، لا على الإنكار والإقصاء.
الكورد وتركيا عند مفترق التاريخ: هل تجرؤ أنقرة على السلام؟
بناء الثقة بين الكورد والدولة السورية الجديدة لن يتم عبر البيانات والخطابات، بل عبر خطوات ملموسة تُترجم على الأرض، الاعتراف الدستوري باللغة الكوردية لغةً رسمية إلى جانب العربية، تمثيل عادل للكورد في البرلمان والمؤسسات السيادية، وضمان إدارة الكورد لمناطقهم ضمن الإطار الوطني العام. كما أن المصالحة الحقيقية لن تُبنى على النسيان، بل على المصارحة والعدالة الانتقالية، كي تُشفى الجراح لا أن تُغطّى.
في نهاية المطاف، المسألة الكوردية هي مرآة الوطن السوري نفسه. فطريقة تعامل الدولة مع الكورد تختبر مدى قدرتها على التحوُّل من دولة قومية ضيقة إلى دولة مواطنة حديثة. لن تنهض سوريا من ركامها إلا بمشروع وطني جامع، يقوم على الاعتراف المتبادل والمساواة في الحقوق والواجبات، مشروع لا يخاف من التعدد، بل يراه مصدر قوة وحياة.
حين يشعر الكورد أن وطنهم يحتضنهم لا يراقبهم، وأن لغتهم تُدرَّس لا تُحظَر، وأنهم شركاء في القرار لا مجرد تابعين له، وحين يدرك العرب أن شراكتهم مع الكورد ليست تهديداً بل ضمانة لوحدة البلاد، عندها فقط يمكن لسوريا أن تستعيد توازنها وتكتب فجرها الجديد.
فالقضية الكوردية ليست ملفاً جانبياً في السياسة السورية، بل البوصلة الأخلاقية والسياسية التي تحدّد إن كانت سوريا الجديدة ستكون دولة مواطنة وعدالة، أم نسخة جديدة من الاستبداد بثوب مختلف.
ليفانت - نيوز

عز الدين الملا
حول الكاتب
- عز الدين الملا
- كاتب وصحفي

لمحة
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!





















