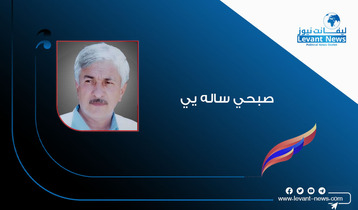-
حمص وسياق إعادة هندسة المجتمع: العنف العشائري كأداة حكم في منظومة ما بعد الدولة

حمص وسياق إعادة هندسة المجتمع: العنف العشائري كأداة حكم في منظومة ما بعد الدولة
الكاتبة: غنى الشومري
لندن
تشهد مدينة حمص مجموعة من الحوادث الأمنية غير المعزولة، لا يمكن النظر اليها دون الخوض ضمن سياق أوسع يُعاد فيه تعريف العلاقة بين السلطة المسلحة والمجتمع من خلال العنف الموجّه. أفادت مصادر محلية بأن مجموعات مسلحة من البدو هاجمت عدة أحياء منها المهاجرين و ضاحيتي الأرمن والعباسية، أطلقت خلالها النار بشكل عشوائي واعتدت على واجهات منازل ومحال تجارية، ما أثار حالة واسعة من الهلع بين السكان. وجاء الهجوم بذريعة الانتقام لمقتل رجل وزوجته في قرية زيدل القريبة، حيث عُثر على جثتيهما مع عبارات طائفية مكتوبة على الجدران، الأمر الذي دفع مجموعات مسلحة من العشائر إلى التعبئة السريعة والتوجه نحو الأحياء السكانية داخل المدينة. وتشير مصادر محلية إلى عمليات إعدام وذبح على أساس الهوية ضد المكوّن العلوي في المدينة.
السرديات الطائفية والعنف المنهجي بعد سقوط الأسد
منذ سقوط نظام بشار الأسد بعد معركة ردع العدوان على يد فصائل ذات توجه جهادي سلفي بقيادة هيئة تحرير الشام، ومبايعة هذه الفصائل لأحمد الشرع قائد التنظيم، شكّلت سردية "التحرير بدون دماء" إحدى الروايات الأساسية للسلطة الجديدة، التي سعت لتسيد دولة ذات مكونات طائفية واثنية متعددة. لكن هذه السردية سرعان ما انهارت مع المجازر التي ارتُكبت في الساحل السوري، والتي استهدفت المكوّن العلوي بعد الإعلان عن حملة استهداف فلول النظام السابق، وتحولت لاحقاً إلى عمليات عسكرية استهدفت المدنيين بعنف غير مسبوق، وأودت بحياة أكثر من ١٥٠٠ شخص في الساحل السوري.
تمسكت الحكومة آنذاك بأن الانتهاكات حصلت على أساس فردي وغير ممنهج بسبب عقلية الثأر، وشهدنا جميعاً المحاكمات التي جرت بحق عشرات من المنفذين من قوات الأمن العام، ممن اتهموا بارتكاب المجازر في الساحل، لكن سرعان ما أُطلق سراح أغلبهم في ما يمكن وصفه بمسرحية درامية بثّت على الهواء مباشرة، ما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويضعف جهود العدالة.
ما يحدث في حمص اليوم يتجاوز عقلية الثأر؛ فالسلطة المؤقتة تمثل نموذج حكم يتجاوز التصنيفات التقليدية للدولة أو الفصيل العسكري، نحو تكوين هجين تتداخل فيه الجهادية العقائدية مع العصبية العشائرية وشبكات اقتصاد الحرب، لتنتج سلطة تقوم على الفزعات والهيمنة الرمزية واستنزاف الجماعات المخالفة كشرط لبقائها وليس انحرافاً عنها، خصوصاً بعد مجازر ريف دمشق والسويداء ضد المكوّن الدرزي، حيث انهارت السرديات الانتقامية في مدن كانت آخر معاقل الثورة أمام حكم بشار الأسد، وظهرت أيديولوجيا إباديّة تهدف إلى إلغاء الاختلاف الديني بكافة أشكاله.
البارزاني، حكاية وطن مقاوم
وعلى الرغم من الجهد الإعلامي المحلي والعربي لتصوير هذا العنف كنتاج فوضى أمنية، فإن نمطه المتكرر يشير إلى ممارسة سياسية مقصودة، حيث يُستهدف المدنيون لإنتاج ما يمكن تسميته بـ"مجتمعات رهينة"، تُحاصر بالخوف وانعدام الخيارات والابتزاز الأمني، وتُنتزع منها حقّها في الاستقرار بوصفه امتيازاً تمنحه السلطة مقابل الطاعة.
تتأسس سلطة الرئيس المؤقت ذو الأصول السلفية الجهادية على ائتلاف متعدد الطبقات يضم فصائل ذات خطاب أصولي، مجموعات عشائرية مسلحة تتحرك بمنطق الثأر والتعبئة السريعة، شبكات اقتصادية تستفيد من الفوضى والنهب والتهريب، وواجهات مدنية تمنح البناء طابع "الحاكم البديل". ويمكن قراءة هذا التشكّل عبر ما يطرحه أوليفر روا حول تفكك الجماعات المؤسسية في الحركات الجهادية واستبدالها بشبكات انضمام قائمة على الانتماء الاجتماعي والولاء الشخصي، كما يتقاطع مع تحليل كوينتن ويكتوروفيتش لطبيعة التجنيد الجهادي بوصفه نتاج شبكات اجتماعية لا مجرد عقائد نظرية. وعند اقتران هذا التكوين العقائدي بالبنى العشائرية، يصبح العنف أداة لإعادة هندسة المجتمع على أساس خطوط الطاعة والخضوع، عبر استخدام العشائر كأدوات استراحة منخفضة الكلفة يمكن إنكار تبعيتها للمركز.
الخيارات الممكنة للمكوّن العلوي في ظل واقع العنف
في ما يتعلق باستهداف العلويين في حمص اليوم، لا يمكن النظر إليه بمعزل عن مسار بدأ في دمشق السومرية والمزة، عبر الضغط الأمني والتضييق الصامت على المجتمع العلوي بهدف التهجير من هذه المناطق ذات التجمعات العلوية في العاصمة. اليوم، تتجه الأنظار نحو حمص، المدينة الأكثر تمزقاً هوياتياً، ذات تاريخ ممتد من المظلومية المتبادلة بين مكوناتها منذ حكم الأسدين، ما يجعلها قنبلة موقوتة قابلة للاشتعال مع أي اهتزاز سياسي أو أمني. وفي هذا السياق، يصبح التهجير القسري للمكوّن العلوي مشروعاً يُحضّر له عملياً من خلال التطبيع المتدرج مع الاستباحة وتفكيك الروابط المجتمعية، ودفع السكان نحو المغادرة كخيار نجاة أخير.
ولا يمكن فهم المشهد في حمص بمعزل عن السياق الجنوبي في السويداء، حيث تعرض المجتمع الدرزي لحصار متدرج وأدوات تهجير قسري، لتتحوّل المدن والمناطق المستهدفة إلى أدوات ضغط سياسي. ما يحدث في حمص هو امتداد عنيف للسياق ذاته، مع اختلاف الأدوات: في الجنوب كانت المجازر مؤسسة لقطيعة مع السلطة ضمن إطار محدود، بينما في حمص يُستخدم العنف العشائري المباشر كأداة "ضرب بالوكالة" لتنفيذ تهجير قسري وإعادة هندسة التوزع الجغرافي، فيما يبقى المركز محتفظاً بصورة الضابط الذي يتدخل لاحتواء الفوضى التي صنع شروطها.
في هذا السياق، يبرز السؤال الأساسي: ما هي الخيارات المتاحة اليوم أمام المكوّن العلوي لمواجهة الاستباحة، خصوصاً مع غياب أي ضامن دولي فاعل، حتى بوجود القواعد الروسية في الساحل؟ الخيارات تبدو محدودة، لكنها تحمل آليات متفاوتة من المخاطرة:
الاستسلام للواقع القائم: قد يوفر تهدئة مؤقتة، لكنه يرسخ معادلة الاستباحة مقابل الحماية ويحوّل المجتمع العلوي إلى ورقة تفاوضية في يد السلطة، كما شهدنا بعد مجزرة الساحل، بما في ذلك عمليات اختطاف النساء.
التحرك نحو تمثيل سياسي مستقل يخاطب المجتمع الدولي: إطار مدني قادر على طلب حماية جماعية وضمان حقوقية، بعيداً عن الاصطفافات الثنائية، وقد يشكّل قناة تفاوضية لتجنّب موجات تهجير جديدة أو انتهاكات ممنهجة.
التحالف مع بعض القوى الخارجية المعادية لسلطة الشرع: كمحاولة لتعزيز التحالف الإيراني أو مع حزب الله ضمن مصالح مشتركة، ما قد يدفع المكوّن العلوي باتجاه مواجهة مع قوى دولية أخرى تسعى للحد من أي تمدد إيراني.
التسلّح الذاتي: وسيلة دفاعية لحماية الأحياء، لكنها تعيد إنتاج منطق الميليشيات وقد تؤدي إلى تصعيد واسع في الوسط السوري.
إعادة تعويم شخصيات من النظام السابق بكافة أرصدتها الشعبية والاقتصادية لبناء مثل هذه التحالفات.
في مدينة مثل حمص، ذات التاريخ المتفجّر والهويات المتداخلة، تتحول هذه الخيارات إلى معادلة شديدة الحساسية؛ فالمدينة ليست مجرد جغرافيا، بل مركز يحتمل أن يتحول إلى قوس صدام يمتد من الساحل إلى حمص ودمشق، وأي خطأ في إدارتها قد يطلق موجة عنف جديدة تعيد إنتاج الحرب بأشكال أكثر سيولة وخطورة.
ويتخذ حضور العصبية العشائرية دوراً محورياً في هذا البناء؛ فهي تحول الخطاب الأصولي من إطار عقائدي إلى أداة تعبئة فورية تقوم على الولاء القربي والمصلحة، وتخلق شرعية للاستباحة تتجاوز منطق العقيدة. ومع غياب مؤسسات حكم راسخة، يتحول الكيان السياسي إلى ما يسميه تيموثي ميتشل “سلطة بلا دولة”—مركز قرار يتحدث بلغة الدولة دون القدرة أو الرغبة في ممارسة وظائفها المدنية.
تداعيات ما جرى في حمص تتجاوز الخسارات الإنسانية الفورية، لتصل إلى إعادة تفعيل سرديات الحرب الطائفية، وتمزيق إمكانية بناء عقد اجتماعي مستقبلي، وتحويل الأقليات إلى كيانات محاصرة وجودياً. في المقابل، لا يمكن التعويل على السلطة القائمة كضامن للحماية، فهي طرف منتج للعنف ومُعاد تشكيله. الحلول الممكنة تنطلق من تمكين المجتمعات المحلية في مسارات حماية مدنية غير ميليشياوية، وبناء أطر إدارة ذاتية تسحب المجال الأهلي من قبضة اقتصاد الحرب، وتفكيك سرديات "المنقذ الأمني" التي تُستخدم لتبرير استمرار العنف، وصولاً إلى تدخل دولي يركّز على حماية المدنيين لا إعادة تأهيل أمراء الحرب كشرائح للاستقرار.
ما يجري في حمص ليس حدثاً عابراً، بل نموذجاً مكثفاً لصيغة حكم تبني قوتها على العنف وتستمد مشروعيتها من استمراره. مواجهة هذا النموذج تتطلب مقاربة تعيد الاعتبار لإنسان المجتمع قبل جغرافيا السلطة، وتحول الأمان من امتياز يمنحه السلاح إلى حق يُستعاد عبر المقاومة المدنية والتماسك المجتمعي، قبل أن يصبح الخوف هو الشكل الوحيد الممكن للتعايش.
قد تحب أيضا
كاريكاتير
تقارير وتحقيقات
الصحة|المجتمع
منشورات شائعة
النشرة الإخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!